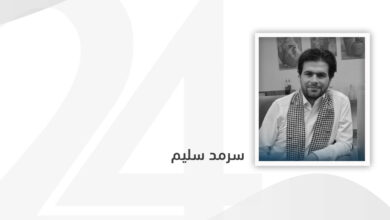الكوجيتو الإيزيدي: أنا أكره، إذن أنا موجود
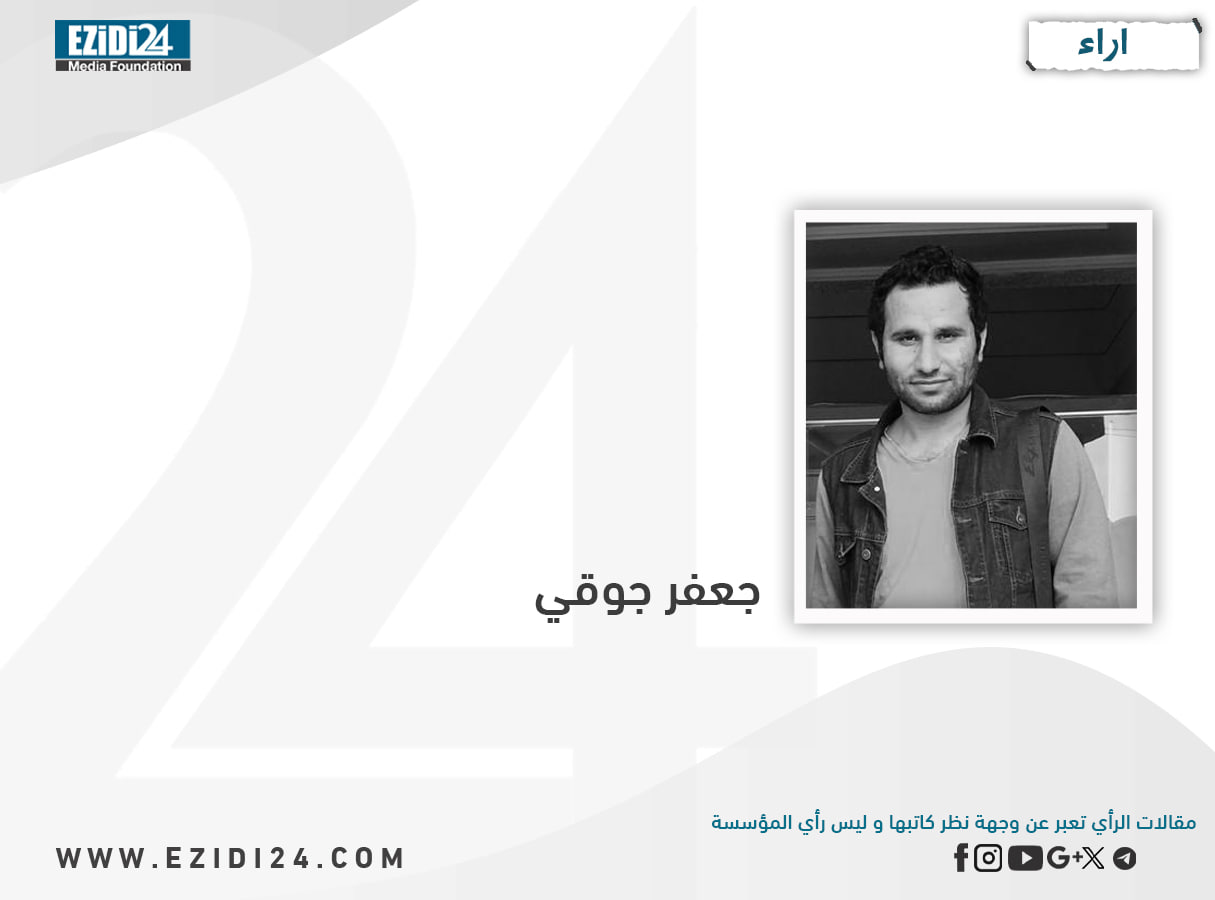
جعفر جوقي
1
الوجود البشري في جوهره وجود تنافسي. منذ ظهور البشر وهم يتنافسون على مصادر الغذاء، المأوى، والجنس – وهذا صحيح بالنسبة لبقية الكائنات الحية أيضًا. هذه التنافسية على المصادر خلقت لدى الإنسان مشاعر وعواطف مختلفة، ومن بينها الكراهية. فإذا كان الحب ضروريًا لضمان الألفة مع الآخر الذي يُلبي أو يُسهم في تلبية الحاجات الأساسية، فإن الكراهية أيضًا ضرورة عندما يتحول الآخر إلى تهديد. بعد التحولات التاريخية الكبرى وبناء مجتمعات أكثر تعقيدًا، بدأت الكراهية تتخذ أشكالًا أيديولوجية وتؤجج نزاعات وحروبًا طاحنة. هذا التحول في شكل الكراهية وتخومها جعلها سؤالًا يطرح نفسه على الدين والفلسفة. الآخر يُصبح عدوًا لأنه يهدد العناصر الثقافية التي نسميها بالقيم، هذه القيم التي تشكل ضميرنا الأخلاقي الحارس لكينونتنا، أو بتعبير فرويدي: “الأنا الأعلى”.
2
للكراهية أواصر غريزية مع ذاتنا، ولا يمكن فصلها عن سياقاتنا الإنسانية، فهي معقولة ومعلولة. لكن الكراهية التي زحفت إلى الفضاء العمومي واهتماماتنا اليومية تحتاج إلى المساءلة. يجب أن نشكّل على هذه الكراهية الخطابية والثقافية الموجهة ضد الوجود الإنساني. نحن لا نكره ما/من يهدد وجودنا فقط، بل نكره من يختلف معنا في السياسة، والدين، والرياضة، والفن، وغيرها من الميادين التي تتحول فيها الكراهية إلى آلية تدميرية للذات. سابقًا كنا نكره إذا كان وجودنا في خطر، لكننا اليوم نعرض وجودنا للخطر لنكره؛ فقد تحولت الكراهية إلى غاية في علاقتنا مع الآخر المختلف.
3
الكراهية شعور عالمي، لا يتعلق بمجموعة دون غيرها، على المستويين الغريزي والثقافي. لكن في الغرب، هناك عمل متواصل لمعالجة الكراهية في الخطاب الثقافي، وهناك دعوات مستمرة لتقبل المختلفين جنسيًا، دينيًا، المهاجرين، وغيرهم من الفئات والمجموعات المعرّضة للكراهية. هذا العمل النظري لمعالجة الكراهية بدأ مع هول الحروب التي أنتجتها الكراهية ضد المختلفين. وللعلم أيضًا دور في ذلك، خصوصًا بعد أن دحض ادعاءات التفوق والنقاء العرقي وغيرها من الهلاوس والضلالات العقدية. الاختلافات التي كانت عائقًا، تحولت إلى جسور تواصل حر مع المختلفين؛ فما يصنعه الآخر مختلف، لكنه لا يهدد ما أصنعه، بل يُغنيه. فالثقافة الغربية الحالية تتضمن بصمات متنوعة، وكل الفئات ساهمت فيها. في المقابل، تحتكرالأغلبية الثقافة الشرقية وهويتها لنفسها وتنفي مساهمة الآخرين فيها. فالأقليات الثقافية بالنسبة للأغلبيات مجرد ثقافات ضالة.
4
المجتمع الإيزيدي، الشنكالي على وجه الخصوص، لا يختلف عن غيره من المجتمعات الشرقية التي وجدت في الكراهية ضالتها. هنا لا أُلصق تهمة بالإيزيدية، فنحن ضحايا الكراهية المفضلون منذ قرون، لكننا في الوقت ذاته لا نختلف عن جلادينا. النصوص الدينية الإيزيدية لا تدعم فكرة الكراهية، لكن الدين فكرة محايثة للواقع فحسب. فالنصوص المحملة بالسلام لدى مختلف الشعوب، لا سيما الشرقية، تحولت إلى مجرد قطع أثرية لا حياة فيها ولا يُعمل بها. هذه الكراهية التي نحن بصدد تفكيكها وجدت طريقها إلى الإيزيدية بعد سقوط النظام في 2003، إثر الاقتحام الحزبي والسياسي للواقع الإيزيدي البدائي. وبعد فرمان 2014، تحولت الكراهية إلى منظور وطريقة للحوار مع الذات والآخر.
لفهم هذا الكوجيتو المُشكل حديثًا، لا بد من التساؤل: لماذا على الإيزيدي أن يكره ليُوجد؟
- أولًا: الكراهية آلية دفاعية للتعامل مع ما يهدد وجودنا. يشهد التاريخ على أن علاقة الإيزيديين مع الآخرين كانت غالبًا في صورة “الضحية والجلاد”. فالإبادات التي ارتُكبت ضد الإيزيديين شكّلت لدينا ذاكرة لعلاقتنا مع الآخرين، وهي ذاكرة الصدمة. معظم الجماعات القوية في الشرق لها حصة في العنف الممنهج ضد الإيزيديين. هذه التجارب تدفعنا إلى الكراهية، لطالما ارتبطت تلك الجماعات في ذاكرتنا بشكل أو بآخر بالإبادات.
- ثانيًا: الكراهية إقصاء أنطولوجي، فعندما نكره شيئًا نحوله إلى مسخ لنُجرده من كينونته الحقة. يصف الإنسان عدوه بـ”الوحش”، ليجرده من طبيعته الإنسانية. قد لا نملك فرصة قتل العدو جسديًا، لكن يمكننا إقصاؤه من دائرة النوع الإنساني. ففي السرديات الشعبية الإيزيدية، تحولت أسماء الأعداء إلى صفات سيئة، ومرادفات لكلمة “الشر”.
- ثالثًا: الكراهية متعلمة، أي أننا نتعلم الكراهية كما نتعلم أي سلوك أو عاطفة. طالما أن المتفوقين كانوا يمارسون الكراهية، فعلينا ممارستها. في التحليل النفسي تُعرف هذه الآلية بـ”التماهي مع الجلاد”. فالضحية بحاجة إلى الانتقام، وبالتالي إلى الوصول إلى مستوى العدو. طالما أن العدو يكره، فعليّ أن أكره بدوري. فالجلاد هو المثل الأعلى للضحية، وفقًا لفهم ألبير كامو.
5
لكون الكراهية عاطفة بدائية وغير عقلانية، فهي تنفجر وتتشظى وتتوزع على كل من هم “آخرون”، وحتى الذات لها حصة منها. لم يعد الإيزيدي قادرًا على تحديد حدود كراهيته؛ فالاختلافات البسيطة باتت تكفي لجعل الآخر مكروهًا. لذا، يظهر الإيزيدي في صورة عدو بالنسبة لغيره من الإيزيديين، لاختلاف انتمائه الحزبي، أو تفسيره، أو حديثه، أو تصويته. الواقع الإيزيدي صورة متكاملة لـ”حرب الكل ضد الكل”. لم تعد هناك أمور نسبية أو حقوق مدنية، بل كبائر فقط. فكل اختلاف يضع الفرد في خانة “العدو”. الكراهية تحولت إلى طقس مقدس في الخطاب الإيزيدي اليومي، حيث لا يكفي أن تفضل طرفًا ما، بل عليك أن تكره وتعادي من يخالفه.
6
ما بعد الكراهية:
الكراهية في صورتها الغريزية آلية معقدة، وقد تؤدي إلى نتائج إيجابية قصيرة الأمد، لكنها تؤدي إلى نتائج سلبية على المدى الطويل. حين تتحول الكراهية إلى استراتيجية، فإنها تشوه الذات وتدمرها. من يكره لا يكره موضوع الكراهية فقط، بل يكره نفسه أيضًا، نتيجة عجزه عن مواجهة ما يكرهه. الخطاب الإيزيدي اليومي يُبرز هذا التشوه في الذات؛ فكل موقف يعرض صاحبه للتهديد والإقصاء دينيًا واجتماعيًا. هذا الاعتماد الكلي على الكراهية سيقود إلى الإرهاب، فكل خطابات الإرهاب تبدأ بالكراهية وتنتهي بها.
7
بدائل الكراهية:
لا أدعو إلى المحبة بالضرورة، فمن الطبيعي أن ننزعج من الاختلاف ونتعصب لرأينا. لكن العالم محكوم عليه بالاختلاف، ويجب علينا تقبّله. كيف؟ أعتقد أن النظر في التجارب التاريخية والحالية في علاقات الشعوب سيساعدنا كثيرًا على تجاوز أزمة الحوار.
في النصف الأول من القرن العشرين، قُتل عشرات الملايين بسبب الأوهام العرقية والأيديولوجية. لكن بعد ذلك استفاق العالم، وبنت الشعوب جسورًا للتواصل، وأصبح التنافس على التقدم العلمي والمعرفي لا على القتل. لم تنتصر أوروبا في حروبها، بل في سلامها؛ حوّلت جحيم الحرب إلى جنة بلا حدود. ما يجمع الشعوب الأوروبية ليس رأيًا واحدًا، بل تقبل الآراء المختلفة. وصحة الرأي تُقاس بآليات الديمقراطية، لا بقوة الكراهية.
لا شك أن سياقات المجتمع الإيزيدي تختلف عن التجربة الأوروبية، لكن الإنسان الإيزيدي لا يختلف عن الآخرين اختلافًا أنطولوجيًا. يمكنه إعادة النظر في وضعه وشرطه الإنساني.
8
نحو خطاب بديل:
نتيجة للجدلية التاريخية، اجتاحت العولمة العالم بأسره تجاريًا، ثم ثقافيًا وسياسيًا. ولحماية نفسه، اختار المجتمع الإيزيدي العزلة عن الثقافات المحلية المحيطة، وساهمت السرديات الدينية والشعبية في ترسيخ هذه العزلة، وربما كانت سببًا رئيسيًا في بقاء الهوية الإيزيدية، وإن كان ثمنها باهظًا.
لكن الوضع لم يعد يسمح بالبقاء في هذه العزلة، وعلينا مغادرتها وتبني استراتيجيات جديدة لحماية هويتنا. في هذا العالم الجديد، هناك ضرورة وجودية لبناء خطاب شامل ومرن. فالكراهية التي نمارسها ليست سوى عرض انتحاري.
هنا بعض الاقتراحات:
- خطاب شامل: توجد مجتمعات إيزيدية متعددة، لكل منها ظروف إنسانية مختلفة، ومصالح ورؤى متباينة. لا يوجد مجتمع إيزيدي معياري تقاس عليه بقية المجتمعات. هذه الاختلافات ليست ثغرات، بل مصادر غنى يمكن استثمارها.
- التواصل غير المشروط: أتبنى هنا مفهوم “العقلانية التواصلية” لهابرماس، يحتاج المجتمع الإيزيدي إلى الخروج من طوره البدائي في التواصل. التواصل البدائي يرى المختلف ككافر/عدو/خائن. ما زال المجتمع حبيس هذه البدائية. العقلانية التواصلية تتيح بيئة حوار غير مشروط، لا بهدف الهيمنة، بل لبناء جسور ممكنة.
- خطاب منفتح على المستقبل: هناك مجتمعات وثقافات تنقرض. لا ضمان لبقاء المجتمع الإيزيدي بعد عقود، لذا علينا تبني استراتيجيات جديدة للحفاظ على هويتنا، على أن تنطلق من الحاضر نحو المستقبل، لا من الماضي. ما نعتز به من ماضينا هو جزء من التاريخ، لكنه لا يصلح لبناء المستقبل. وإذا ما تأملنا العقد الأخير من تاريخنا، سندرك أن طريقتنا في التعامل مع ذاتنا الإيزيدية تحتاج إلى إعادة نظر نقدية.