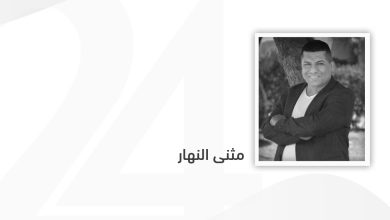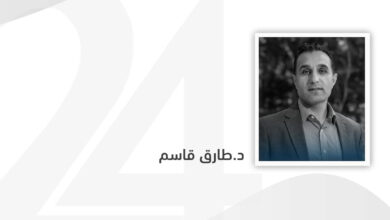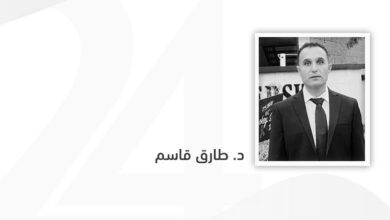المقدس المحتل: حين تصادر السلطة روح الجماعة

سرمد سليم
حين تسرق المعابد، لا يسرق الحجر وحده، بل تسرق معه الذاكرة، والطمأنينة، والقدرة على أن نكون. لالش، ذلك المكان الذي كان يجمع الروح الإيزيدية في نقطة واحدة من القداسة، لم يعد ملكا لمن يحجّون إليه، بل صار خاضعا لسلطة سياسية تحوله من فضاء روحي إلى أداة سيطرة. وشنكال، الأرض التي شهدت الإبادة والبقاء معا، تجد نفسها اليوم في مواجهة سؤال وجودي لا يطاق: كيف تحيا جماعة حين يسلب منها مركز قداستها؟ كيف تتنفس روح جردت من معبدها؟ هذا ليس سؤالا دينيا فحسب، بل هو سؤال عن معنى الوجود الجماعي نفسه، عن ماهية الانتماء حين تحتل رموزه، عن إمكانية البقاء حين تتحول المؤسسات الروحية إلى مسارح لممارسة القوة.
المعبد، في أي ثقافة، ليس مجرد بناء حجري أو مكان للطقوس. إنه المركز الأنطولوجي الذي تنبثق منه الهوية وتعود إليه. في الفكر الديني القديم، كان المعبد يعتبر “سُرّة العالم”، النقطة التي تتقاطع فيها السماء مع الأرض، والزمن مع الأبدية. لالش، بالنسبة للإيزيديين، هو هذا المركز الذي يعيد ترتيب الفوضى، الذي يمنح الحياة اتجاها، والألم معنى، والموت أملا في استمرارية ما. لكن حين يحتل المعبد، لا يحدث مجرد انتهاك مادي، بل انهيار رمزي كامل. المعبد المحتل يفقد قدرته على أن يكون مكانا آمنا للمعنى. يتحول من فضاء للقداسة إلى موقع للصراع، من مكان للسكينة إلى ساحة للمناورة السياسية. وحين يسيطر حزب سياسي معين على المجلس الروحاني في لالش، فإنه لا يدير مؤسسة دينية فحسب، بل يمارس نوعا من الاستعمار الرمزي، حيث يعاد تعريف المقدس وفقا لمصالح السلطة، ويحول الدين من تجربة جماعية مشتركة إلى أداة انضباط وولاء.
المجلس الروحاني، في أصله، كان تجسيدا لتعددية الإيزيدية وتوازنها الداخلي. كان يمثل مختلف الطبقات الروحية، وكانت قراراته تعكس توافقا لا فرضا. لكن حين تسيطر عليه سلطة سياسية خارجية، يفقد هذا التوازن. يصبح صوتا واحدا يملي، لا أصواتا متعددة تتحاور. يصبح الدين خطابا من الأعلى، لا تجربة من الداخل. وهنا تكمن الكارثة الوجودية: الإيزيديون في شنكال يجدون أنفسهم في موقف مزدوج من الاغتراب. من جهة، هم بعيدون جغرافيا عن لالش، المحاصر بالحواجز والسيطرة السياسية. ومن جهة أخرى، حتى لو وصلوا إليه، فإنهم سيجدون أن المجلس الروحاني الذي يفترض أن يمثلهم بات يدار بمنطق لا يعكس إرادتهم ولا حاجاتهم الروحية. إنهم غرباء في معبدهم، منفيون في مقدسهم.
الفراغ الرمزي الذي تركه احتلال لالش ليس مجرد غياب مؤسسة، بل هو أزمة معنى. حين يفقد الإنسان ارتباطه بمركز قداسته، يفقد معه إحساسه بالاتصال الكوني، بالانتماء إلى نظام أكبر من ذاته الفردية. في الفلسفة الوجودية، يعبر هذا عن تجربة اللامعنى التي تحدث عنها كامو وسارتر: الإحساس بأن الوجود صار عبثيا، لأن المرجعيات التي كانت تمنحه اتجاها قد انهارت أو سلبت. شنكال، بعد الإبادة، تعيش هذه التجربة بعمق مضاعف. الإبادة لم تقتل الأجساد فقط، بل حاولت محو الهوية ذاتها. والبقاء، في هذا السياق، ليس مجرد استمرار بيولوجي، بل فعل مقاومة وجودية ضد العدم. لكن هذا البقاء يحتاج إلى معنى، إلى إطار رمزي يعيد للجماعة شعورها بأنها جماعة، بأن لها هوية مشتركة وقيم توحدها ومستقبل تبنيه معا.
الحاجة إلى مرجعية دينية في شنكال، إذن، ليست نزوة سياسية أو تقليدا أعمى لنماذج أخرى، بل هي حاجة وجودية عميقة: حاجة إلى إعادة بناء المركز، إلى خلق فضاء روحي جديد يعوض عن لالش المسروق، إلى صوت ديني يعكس تجربة شنكال المحددة، تجربة الصمود، والألم، والأمل. لكن ما نوع المرجعية التي يمكن أن تبنى؟ الحذر من الاستنساخ الأعمى لنماذج جاهزة كالمرجعية الشيعية مفهوم ومبرر، لكنه لا يعني رفض فكرة المرجعية ذاتها. بل يعني أن على الإيزيديين في شنكال أن يبتكروا مرجعيتهم الخاصة، انطلاقا من بنيتهم الدينية الأصلية، ومن تجربتهم التاريخية الفريدة.
المرجعية هنا لا تعني بالضرورة شخصا واحدا يحتكر القرار، بل يمكن أن تكون مؤسسة جماعية تعكس التعددية الإيزيدية: مجلس يمثلون مختلف العشائر والطبقات، يجتمعون في شنكال، يناقشون القضايا الدينية والاجتماعية، ويصدرون قرارات بالتوافق لا بالفرض. مرجعية تبنى من الأسفل، لا من الأعلى. تستمد شرعيتها من تمثيلها الفعلي للجماعة، لا من فرضها بقوة السياسة أو المال. هذا النموذج يمكن أن يكون بديلا وجوديا عن لالش المحتل: مركز جديد يولد من رحم الأزمة، لا ليحل محل لالش، فلالش لا يعوض، بل ليكون امتدادا حيا له في سياق جديد، يعكس حاجة الجماعة إلى السيطرة على مصيرها الروحي.
السيطرة على المؤسسات الدينية ليست ظاهرة جديدة. عبر التاريخ، سعت السلطات السياسية إلى احتواء الدين أو السيطرة عليه، لأنها تدرك أن من يتحكم بالمقدس يتحكم بالناس. الدين يمنح الشرعية، ويُبرر القرارات، ويوجه الولاءات، ويخفف من احتجاج المظلومين عبر وعود بالعدالة الأخروية. لهذا، تحويل المقدس إلى أداة سيطرة هو إغراء دائم للسلطة. لكن حين يستعمل الدين لخدمة السياسة، يفقد روحه. يتحول من تجربة تحررية تمنح الإنسان معنى وتربطه بالأبدي، إلى آلة انضباط تخضعه وتسكته. وهنا يحدث ما يمكن تسميته الاستلاب الرمزي المزدوج: الإنسان لا يحرم فقط من حريته السياسية، بل يحرم أيضا من حريته الروحية. يجبر على أن يطيع مرجعية لا تمثله.
السيطرة على المجلس الروحاني لا تحتاج إلى دبابات أو قمع مباشر. إنها تمارس عبر العنف الناعم: عبر التمويل، فمن يملك المال يملك القرار، عبر التعيينات، فمن يختار الأعضاء يحدد التوجه، عبر التحكم في الخطاب، فما يقال وما يسكت عنه يشكل الوعي الجماعي، وعبر الإقصاء، فمن يسمح له بالوصول ومن يمنع يرسم خريطة القوة. هذه الأدوات تحول المقدس إلى مسرح سياسي دون أن يفقد مظهره الديني. الناس يستمرون في الذهاب إلى لالش، في تقبيل العتبات، في إشعال الشموع، لكنهم لا يدركون أن القرارات التي تتخذ باسم الدين لم تعد تعكس روح الجماعة، بل إرادة السلطة المسيطرة. إنه نوع من الاحتلال الخفي، الذي يُبقي على الشكل بينما يفرغه من المضمون. والأخطر من ذلك، أن هذا النوع من السيطرة يخلق انقساما داخليا في الجماعة: بين من يقبلون بالأمر الواقع خوفا أو براغماتية، ومن يرفضونه إحساسا بالخيانة. هذا الانقسام يضعف الجماعة من الداخل، يجعلها أقل قدرة على المقاومة الجماعية، وأكثر عرضة للتفتت.
إذا كانت لالش قد سلبت مؤقتا، فإن شنكال يمكن أن تكون مختبر الإبداع الروحي. هنا، في الأرض التي صمدت ضد الإبادة، يمكن أن يولد نموذج جديد للتنظيم الديني، نموذج يستعيد روح الإيزيدية دون أن يتورط في تكرار أخطاء المركزية أو الخضوع للسلطة السياسية. المرجعية التي تحتاجها شنكال يجب أن تبنى على مبادئ واضحة: الاستقلالية، فلا يجوز أن تخضع لأي سلطة سياسية، سواء كانت كردية أو عراقية أو غيرها، واستقلاليتها هي ضمانة مصداقيتها. التمثيل الحقيقي، فيجب أن تعكس تنوع الجماعة الإيزيدية، لا أن تفرض من فوق، وهذا يعني انتخاب الأعضاء أو اختيارهم بطرق شفافة تعكس إرادة الناس. التعددية الداخلية، فبدلا من مرجع واحد، يمكن أن يكون هناك مجلس مراجع يضم أصواتا متنوعة، يتداولون ويتوافقون، مع احترام الاختلاف الداخلي. الانفتاح والشفافية، فالقرارات الدينية يجب أن تناقش علنا، والأسباب تشرح، والاعتراضات تسمع، لأن الدين الحي يتنفس بالحوار، لا بالأوامر. والارتباط بالواقع، فالمرجعية ليست برجا عاجيا، بل يجب أن تعنى بقضايا الناس اليومية: الزواج، التعليم، الميراث، الصراعات الاجتماعية، بناء المدارس الدينية، حفظ التراث الشفهي.
ما بعد الإبادة، يحتاج المجتمع الإيزيدي إلى أكثر من مجرد مؤسسة دينية. يحتاج إلى فضاء للشفاء الجماعي. المرجعية الدينية، إذا بنيت بوعي، يمكن أن تكون هذا الفضاء: مكان يلتئم فيه الجرح الجماعي، تروى فيه القصص، تحفظ فيه الذاكرة، تعاد فيه صياغة الهوية بعد الصدمة. الطقوس الدينية، في هذا السياق، ليست مجرد تكرار للماضي، بل إعادة تأسيس للحاضر. حين يجتمع الناس للصلاة أو للاحتفال بعيد ديني، فهم لا يستذكرون الماضي فقط، بل يعلنون: نحن ما زلنا هنا، نحن لم ننته، نحن نعيد بناء أنفسنا. الدين، في هذا المعنى، يصبح فعل مقاومة وجودية ضد المحو.
يحتاج المجتمع الإيزيدي إلى أكثر من مجرد مؤسسة دينية. يحتاج إلى فضاء للشفاء الجماعي
الفلسفة الوجودية، خاصة في نسختها السارترية، ترى أن الإنسان محكوم بالحرية. لا توجد طبيعة إنسانية سابقة، لا قيم ثابتة، لا معنى جاهز. الإنسان يُلقى في العالم، ويجب عليه أن يخلق معناه بنفسه. هذه الحرية مرعبة، لأنها تعني أيضا المسؤولية الكاملة: لا يمكن أن تُلقي باللوم على الله، أو القدر، أو المجتمع. أنت وحدك من يختار، وبالتالي أنت وحدك المسؤول. لكن هذه الحرية المطلقة غير محتملة لمعظم البشر. لهذا يلجأ الإنسان، بحسب سارتر، إلى سوء النية، أي إلى خداع الذات، إلى التظاهر بأنه مجبر، مقيد، محكوم بقوى خارجية، كي يتهرب من عبء الحرية. الدين، من هذا المنظور، يمكن أن يفهم كشكل من أشكال سوء النية: الإنسان يتخلى عن حريته، يُسلمها لله أو للمرجع الديني، كي يرتاح من قلق الاختيار. لكن هذا تفسير مبسط ومجحف.
الدين، في عمقه، ليس نقيضا للحرية، بل إطار لممارستها. القيم الدينية، والطقوس، والمعتقدات، لا تلغي الاختيار، بل تمنحه معنى. تُحول الحرية من عبثٍ مخيف إلى مسؤولية هادفة. حين أختار أن أكون صادقا، لا لأن الصدق يخدم مصلحتي، بل لأن ديني يقول إن الصدق قيمة مقدسة، فإنني لا أتخلى عن حريتي، بل أُمارسها ضمن إطار يمنحها وزنا وجمالية ومعنى.
بول تيليش، اللاهوتي الوجودي، يرى أن الإيمان ليس إلغاءً للشك، بل شجاعة على الرغم من الشك. الإنسان المؤمن لا يملك يقينا مطلقا يريحه من القلق الوجودي، بل يختار، بحرية، أن يثق في معنى أكبر من ذاته، أن يراهن على أن الوجود ليس عبثا، وأن الحياة، رغم الألم، تستحق أن تُعاش.
في حالة الإيزيديين، المرجعية الدينية لا تعني إلغاء الحرية، بل إعادة تأسيس فضاء يمكن فيه أن تمارس الحرية بأمان. بعد الإبادة، بعد انهيار المؤسسات، بعد هدم المزارات، الحرية المطلقة تعني الضياع. المرجعية تمنح الجماعة إطارا يعيد تنظيم الفوضى، يعيد ربط الأفراد ببعضهم، يعيد منح الحياة اتجاها. حين تسرق المعابد، تولد الحاجة إلى بنائها من جديد، لا بالحجر فقط، بل بالمعنى. شنكال، في مواجهة احتلال لالش واستيلاء حزب سياسي على المجلس الروحاني، تقف أمام خيار وجودي حاسم: إما الاستسلام للفراغ، أو إبداع مركز جديد.
المرجعية الدينية التي تحتاجها شنكال ليست استنساخا لنماذج جاهزة، وليست احتكارا لرجل دين مسن، وليست خضوعا لسلطة سياسية. إنها مشروع جماعي لاستعادة السيادة الرمزية، لإعادة بناء فضاء يمكن للروح أن تتنفس فيه، للجماعة أن تلتئم، وللفرد أن يشعر بأنه ينتمي إلى معنى أكبر من موته. الحرية لا تُبنى ضد المقدس، بل مع المقدس، حين يفهم المقدس لا كسلطة تُخضع، بل كمعنى يُحرر. حين تتحول المرجعية من وصاية إلى حوار، من فرض إلى تمثيل، من احتكار إلى تعددية، عندها فقط يمكن أن تولد مرجعية حية، ترتبط بالواقع، وتخدم الجماعة، وتعيد للإيزيدية كرامتها الروحية. لالش سيبقى المركز الرمزي الأول، لكن شنكال يمكن أن تكون المركز الحي، المكان الذي يُعاد فيه ابتكار الإيزيدية بعد الصدمة، لا كنسخة باهتة من الماضي، بل كتجربة حية تُواجه الحاضر بشجاعة وتُبشر بمستقبل ممكن. المقدس لا يموت حين تحتل معابده. يموت فقط حين نتوقف عن إعادة ابتكاره.