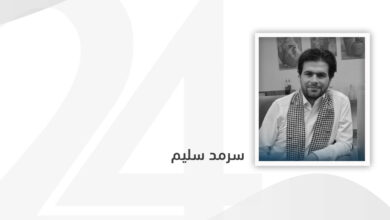الإيزيدية والحداثة: صراع الوجود في زمن التفكك

سرمد سليم
عندما تحدث هيدغر عن «الوجود والزمان» لم يكن يتصور أن شعباً بأكمله سيعيش هذا التوتر الوجودي بشكل دراماتيكي.
الإيزيدية اليوم تقف على حافة الانقراض الوجودي، ليس فقط بسبب الإبادات الجسدية، بل بسبب انهيار منظومتها الرمزية في مواجهة الحداثة. المسألة لم تعد تتعلق بالبقاء البيولوجي للجماعة، بل بالبقاء الأنطولوجي للهوية نفسها. إن ما يحدث للإيزيدية اليوم هو تجسيد مأساوي لما أسماه والتر بنيامين «تدمير الهالة». التقنية الحديثة، وسائل الإعلام، العولمة، كلها تعمل على تدمير القداسة التقليدية للرموز الإيزيدية. الشاب الإيزيدي اليوم في برلين أو باريس -على سبيل المثال- يحمل هاتفاً ذكياً يربطه بالعالم كله، بينما جده كان يعيش في كون مغلق تحكمه قوانين مقدسة لا تُمس.
كيف لهذا الشاب أن يؤمن بحرمة الخس والملفوف في عالم ماكدونالدز؟
كيف له أن يقبل الطبقات الوراثية في مجتمع يؤمن بالمساواة؟ المشكلة أن النخبة الإيزيدية، تلك القلة المتعلمة، تعيش انفصاماً معرفياً مدمراً. فهي تحمل درجات جامعية في الفلسفة والاجتماع والتاريخ، لكنها في المجتمع الإيزيدي تتحدث بلغة القرون الوسطى. هذا الانفصام ليس مجرد تناقض شخصي، بل هو أزمة حضارية عميقة. لأن هؤلاء هم من يُفترض بهم أن يقودوا التجديد، لكنهم أسرى خوف مزدوج: خوف من المجتمع التقليدي الذي يتهمهم بالكفر، وخوف من المجتمع الحديث الذي يراهم متخلفين. النص الديني الإيزيدي لم يعد قادراً على الإجابة على أسئلة العصر. عندما يسأل شاب إيزيدي عن معنى الحياة في عالم نيتشوي مات فيه الإله، فإن النص التقليدي يقدم له إجابات عن أسئلة لم يعد يطرحها. وعندما تسأل فتاة إيزيدية عن حقوقها في مجتمع نسوي، فإن النص يقدم لها منظومة أبوية لا تعترف بوجودها كذات مستقلة. الأمر الأكثر إيلاماً هو أن محاولات “التحديث” التي تحدث هنا وهناك لا تعدو كونها تجميلاً سطحياً لجثة فكرية. يقولون مثلاً أن الإيزيدية تحترم المرأة لأن الشمس مؤنثة، متناسين أن هذا الاحترام الرمزي يتناقض مع التمييز الفعلي ضد المرأة في كل نواحي الحياة الاجتماعية. أو يقولون أن الإيزيدية ديانة سلام لأنها لا تبشر، متناسين أن عدم التبشير ليس اختياراً أخلاقياً بل عجزاً عن الحوار مع الآخر. ثمة مفارقة أخرى تكشف عمق الأزمة: الإيزيديون في الشتات يتمسكون بالتقاليد أكثر من الإيزيديين في الوطن.
هذا التمسك ليس إيماناً حقيقياً، بل رد فعل دفاعي ضد الذوبان في المجتمعات الغربية. إنه تمسك عصابي بالماضي كوسيلة للهروب من قلق المستقبل. لكن هذا التمسك يخلق جيلاً إيزيدياً مشوهاً: لا هو قادر على العيش في الحداثة بسلام، ولا هو قادر على العودة إلى الأصالة بصدق. المسألة تتعقد أكثر عندما ندرك أن الهجرة الجماعية بعد 2014 لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل كانت انتقالاً حضارياً قسرياً من القرن الخامس عشر إلى القرن الحادي والعشرين. آلاف الإيزيديين وجدوا أنفسهم فجأة في مجتمعات ما بعد حداثية دون أي تأهيل ثقافي أو نفسي. النتيجة كانت صدمة حضارية مدمرة، ليس فقط للأفراد، بل للجماعة ككل. في هذا السياق، تبدو المناقشات حول الأمير والمؤسسة الدينية وكأنها حوار طرشان. الجميع يتحدث عن إصلاح مؤسسة لم تعد لها وظيفة في العالم الحديث. أشبه بمن يناقش إصلاح المحراث في عصر الطائرات. المؤسسة الدينية الإيزيدية نشأت لحماية الجماعة في عالم القرون الوسطى، لكن هذا العالم لم يعد موجوداً.
لا يمكن حماية الإيزيدية اليوم بالطرق التقليدية، لأن التهديد لم يعد خارجياً فقط، بل أصبح داخلياً أيضاً. السؤال الحقيقي ليس كيف نحافظ على الإيزيدية، بل أي إيزيدية نريد أن نحافظ عليها. هل نريد إيزيدية متحفية تعيش في كبسولة زمنية، أم إيزيدية حية قادرة على التفاعل مع العصر؟ الخيار الأول يضمن الموت البطيء، والخيار الثاني يحمل مخاطر التحول الجذري. لكن كما قال سارتر، الإنسان محكوم عليه بالحرية، والجماعات أيضاً محكومة عليها بالاختيار. المسألة في النهاية ليست مسألة دين أو تراث، بل مسألة وجود. والوجود، كما علمنا الفلاسفة الوجوديون، ليس معطى، بل مشروع. الإيزيدية كمشروع وجودي تحتاج إلى إعادة تعريف جذرية، وإلا فإن المستقبل لن يحمل سوى المزيد من المآسي والمهازل.