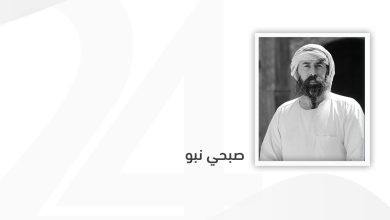الإصلاح الإيزيدي: جدل العقل والذاكرة،نحو ذاكرة نقدية وهوية متجددة

سرمد سليم
الإصلاح، في جوهره، ليس شعاراً سياسياً ولا حركة اجتماعية فحسب، بل هو – كما قال سقراط – “فنُّ أن تعرف نفسك”. والمجتمع الذي لا يجرؤ على مواجهة ذاته، سيظل عالقاً في ماضيه، كمن يمشي وهو ينظر إلى الوراء، فيتعثر بالحاضر ويسقط من المستقبل. إن سؤال الإصلاح، بالنسبة للإيزيديين، هو سؤال وجودي: كيف نحيا؟ وكيف نواصل الحياة في عالم تغيّر أكثر مما نحتمل؟ لكن هل يجب أن نختار حقاً بين “أمة ذاكرة” و”أمة مستقبل”؟
ربما تكمن المشكلة في طبيعة هذا التقسيم نفسه. فالذاكرة ليست كتلة صماء واحدة، بل طبقات متعددة من الخبرة والمعنى. وما نحتاجه ليس رفض الذاكرة ولا تقديسها، بل تطوير ما يمكن أن نسميه “الذاكرة النقدية” – ذاكرة تحفظ وتساءل في آن واحد. هنا يحضرنا الفيلسوف الألماني هايدغر، حين قال إن “الوجود الحقيقي هو الوجود الذي يفتح أفقه نحو المستقبل”. لكن هايدغر نفسه لم يدع إلى القطيعة مع الماضي، بل إلى “التملك الأصيل للتراث” – أي إعادة اكتشاف الماضي بعيون الحاضر، لا تكراره كطقس أجوف. فما معنى أن نتمسّك بذاكرة الألم إن لم نكن قادرين على تحويلها إلى حكمة للحياة؟ وليس الإصلاح هدماً للتراث، بل تحريرٌ له من الجمود. فقد كتب أوغسطين قديماً: “الزمن لا يذهب، بل نحن الذين نرحل فيه”. الإصلاح بهذا المعنى، ليس إلا محاولة لإعادة ترتيب رحلتنا في الزمن، بحيث لا نصبح أسرى لماضٍ يُثقل الخطى، ولا عبيداً لحاضرٍ يُنكر المستقبل. لكن لنتعمق أكثر: الهوية الإيزيدية، شأنها شأن كل هوية حية، ليست “جوهراً” ثابتاً نحرسه كما نحرس كنزاً، بل “صيرورة” متجددة نشارك في صنعها. وهذا ما قصده الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون حين ميّز بين “الزمن الآلي” المقسم إلى وحدات منفصلة، و”الديمومة الحية” التي تنساب وتتراكم.
الهوية الإيزيدية ليست مجموعة طقوس محفوظة في الذاكرة، بل ديمومة حية تستوعب التجربة وتعيد تفسير نفسها. أما نيتشه، فقد ذهب أبعد حين اعتبر أن “القوة العظمى هي في القدرة على إعادة التقييم”. لكن في السياق الإيزيدي، يجب أن نكون حذرين من تطبيق “إعادة التقييم” النيتشوية بلا روية. فالمجتمعات التي تعرضت لصدمات الإبادة والنزوح والتهجير تجد في تراثها ملاذاً وجودياً، وليس مجرد موضوع للنقد الفلسفي. هنا تبرز الحاجة إلى ما يسميه هابرماس “التوازن بين العقل والتراث” – أي القدرة على نقد التراث دون تدميره، وتجديده دون تشويهه. فالمقدس ليس بالضرورة عدواً للعقل، بل يمكن أن يكون مصدر إلهام له، إذا ما تعاملنا معه كـ”سؤال مفتوح” وليس كـ”إجابة مغلقة”. وهذا ما قصده كانط حين دعا الإنسان إلى أن يخرج من “قصوره الذاتي”، أي من حالة الخضوع لما تعوّد أن يتلقاه دون مساءلة. لكن الخروج من القصور لا يعني بالضرورة رفض كل ما ورثناه، بل إخضاعه للحوار والتأمل. الإيزيديون اليوم يحتاجون إلى حوار متعدد المستويات: حوار داخلي مع تراثهم، وحوار خارجي مع العالم من حولهم، وحوار أجيال بين الكبار والشباب. الحقيقة ليست جوهراً صلداً نحتفظ به في صندوق، بل نهرٌ يجري كلما انفتح مجراه – وهي فكرة تتردد عبر تقاليد فلسفية متنوعة، من هيراقليطس اليوناني إلى ابن عربي الصوفي الذي تحدث عن “الحقيقة المتجلية” في أشكال متجددة. لكن ربما أهم ما يحتاجه الإصلاح الإيزيدي هو أن يكون “تراكمياً” وليس “انقلابياً”. أي أن يبني على ما كان، لا أن يهدمه ويبدأ من الصفر.
فالتغيير الحقيقي، كما علمتنا تجارب الشعوب، لا يحدث بالثورة على الماضي، بل بالثورة داخله – باكتشاف بذور المستقبل في رحم التراث نفسه. هذا ما تشير إليه فلسفة “التأويل” عند غادامير، الذي رأى أن فهم النص القديم يتطلب “انصهار الآفاق” بين زمن النص وزمن القارئ. الإيزيديون لا يحتاجون إلى “فهم” نصوصهم القديمة فحسب، بل إلى “إعادة تفسيرها” في ضوء تجربتهم المعاصرة، بحيث تصبح هذه النصوص مصدر قوة، لا قيود. لقد قال هيراقليطس قبل آلاف السنين: “لا تنزل النهر مرتين”، لأنه يتجدد باستمرار. والإصلاح، بالمعنى العميق، هو أن ندرك أننا لا ننزل نهر التاريخ مرتين، وأن علينا أن نُحسن السباحة فيه، وإلا جرفنا التيار. لكن السباحة في النهر لا تكون فردية، بل جماعية.
والإصلاح الحقيقي لا يكون بقرار من “مفكر وحيد” أو “شخصية ملهمة”، بل بحوار جماعي يشارك فيه الجميع: رجال الدين والمثقفون، الشباب والكبار، المقيمون في الوطن والمهجرون. فالحقيقة، كما قال الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، تولد من التفاعل، لا من الانعزال. في النهاية، الإصلاح الإيزيدي ليس هروباً من الذات، بل عودة إليها – لكن عودة واعية، نقدية، محبة. عودة تحمل أسئلة الحاضر إلى حكمة الماضي، وتحمل إجابات الماضي إلى تحديات المستقبل. إنه، بعبارة أخرى، فن العيش في الزمن بكل أبعاده، دون أن نصبح أسرى لأي منها.